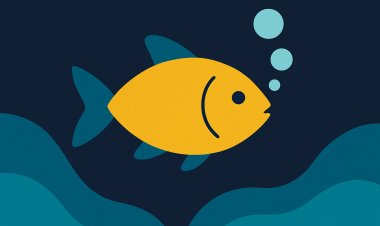أسطورة أوديب الملك: حين يتحوّل الهروب من المصير إلى طريقٍ إليه
أسطورة الملك أوديب كما رواها سوفوكليس، تروي مأساة رجل فرّ من نبوءة قدره، ليجد نفسه في قلبها. بين قتل الأب والزواج بالأم، تكشف القصة عن عمق المأساة الإغريقية وحتمية المصير، وتنتهي بإدراك مُرّ يقود إلى العمى والتيه والندم.

أسطورة أوديب: حين يصبح الهروب من المصير طريقًا إليه
إن كانت ثمّةَ قصةٌ تُجسِّد حتميّةَ المصير، وتجعله قدَرًا لا مفرّ منه، فإنّ أسطورة الملك أوديب تظلّ المثال الأبلغ والأوضح على ذلك. تبدأ الأسطورة بنبوءةٍ مشؤومة، يعقبها سعيٌ حثيثٌ للتملّص منها، لكنها ما تلبث أن تسفر، في النهاية، عن تحققها المحتوم. فلقد كان القضاءُ والقدر، في نظر الإغريق القدماء، أمرًا لا مردّ له ولا مهرب منه. فالنبوءات، وإن بدا ظاهرُها متروكًا للتأويل، وتتبدّل على وجوهٍ شتّى، إلا أنّها – لا محالة – واقعةٌ بوجهٍ من الوجوه، كائنةٌ كما قُدّر لها أن تكون.
الملك أوديب: بداية النهاية
لقد اقترن مفهوما المولد والمصير اقترانًا وثيقًا في الثقافة الإغريقية؛ إذ آمن الإغريق بأنّ روح الإنسان، ما إن تُنفخ فيها الحياة، حتى تُشدَّ بخيطٍ قُدّر لها أن تسير فيه حتى منتهاه. تجسَّد هذا التصوّر في هيئة ثلاث آلهة رمزية يُعرفن بـ«المويراي» أو «آلهة القضاء»، يُنسجن خيطَ القدر لكلّ مولودٍ يولد.
يرمز هذا الخيط إلى مسيرة الإنسان ومآله، وتُحدَّد فيه المنعطفات الكبرى في حياته، دون أن يملك فكاكًا منها مهما تعدّدت خياراته. ولئن أُوتي الإنسان شيئًا من الإرادة، فإنّه لا يملك ردَّ قضاءٍ نُسج له من قبل. فإذا بلغ أجله، قطعت «المويراي» خيطه، وأُسدلت الستارةُ على أيامه.
وفي أسطورة أوديب الملك، حُبك خيط المصير على أهوالٍ منذ المهد. فعند مولده، تلقّى والداه نبوءة تنذر بأنّ وليدهما سيشبّ ليقتل أباه، الملك لايوس. فدبّ الرعب في قلبي لايوس وزوجته جوكاستا، فاختارا قرارًا مشؤومًا: التخلّي عن الطفل درءًا للفاجعة.
شدّ لايوس قدمي الرضيع بدبّوس، وأمر جوكاستا أن تجهز عليه. فلما عجزت عن ذلك، أوعزت إلى أحد الخدم أن يطرحه في الجبل.
وكان ذلك الفعل، في الثقافة الإغريقية، يُعرف بـ«الكشف» – أي أن يُترك الرضيعُ في موضعٍ ناءٍ، لتقضي الطبيعةُ في أمره. وسيلةٌ يتفادَيان بها القتلَ المباشر، دون أن يُبقيا الطفل بينهما. فهكذا تُرك أوديب معلّقًا على غصن شجرة، ينتظر أن تقول الأقدار كلمتها الأخيرة.
راعي الغنم يُنقذ الطفل من الموت
لكنّ الأقدار لم تكتب لأوديب أن يهلك في شعاب الجبل، فقد رقّ قلب الراعي الذي أُوكِل إليه أمر الكشف، فعصى الأمر، ومدّ يده إلى الغصن، فحلَّ الرضيع منه. ثم سلّمه إلى رسولٍ حمله إلى مملكة كورنث المجاورة. ويا للعجب! هناك، كان الملك والملكة يلهفان إلى وليدٍ يتبنّونه، فاحتضنا أوديب بفرحٍ غامر، دون أن يدروا من هو، ولا حتى الراعي الذي لم يُكشف له اسمُ الطفل الذي أُمر بالتخلّص منه.
وقد سجّل سوفوكليس هذه القصة في مسرحيته الخالدة الملك أوديب، وفيها يروي الراعي، وقد شاخ، كيف رقّ قلبه للرضيع المعلّق، فامتدت يدُه بالرحمة، لا يدري أنّ ذلك المعروف الذي أراد به نجاةً، سيكون مفتتح المصيبة الكبرى.
أوديب والخطيئة الأولى
شبّ أوديب، وبلغ مبلغَ الرجال، حتى سمع نبوءةً تهزّ الوجدان: "سوف تقتل أباك وتتزوّج أمك". فهاله الأمر، وارتعدت فرائصه، فقرّر الفرار من كورنث، رجاءً أن يقطع خيوط المصير قبل أن تُحيط به. ولم يدرِ، في سذاجةٍ مغلفة بالحكمة، أنّ الملك والملكة اللذين ربّياه لم يكونا أبويه.
وفي أثناء رحلته، التقى رجلًا غريبًا على الطريق، فاحتدم بينهما الخلاف، حتى قتل أوديب ذاك الرجل في نوبة من الغضب العنيف. ولم يكن يدري أنّه، إذ يفعل، يخطو أولى خطواته على درب النبوءة، إذ قتل أباه لايوس، دون أن يعلم.
طيبة وأحجية السفنكس
قادت الأقدار أوديب إلى طيبة، المدينة المبتلاة بوحشٍ مريع يُدعى "السفنكس"، مخلوقٍ غريب، نصفه امرأة ونصفه أسد، يلقي بالأحاجي على المارة، فمن عجز عن حلّها، التهمه، ومن أخطأ، ابتلعه.
قبل ذلك ببرهة، خرج لايوس إلى معبد دلفي يطلب العون، لكنّه سقط قتيلًا على الطريق على يد ابنه، دون أن يعرف كلٌّ منهما صاحبه.
وها هو أوديب يدخل طيبة، فيراها تئنُّ من فزعها، تبكي ملكها الذي قيل إنّه قُتل على أيدي "لصوصٍ مجهولين". فيعرض أوديب، وهو الأمير الغريب، أن يواجه السفنكس ويحلّ لُغزه.
وقف أوديب أمام السفنكس، فألقى عليه لغزه المشهور: «ما الكائن الذي يمشي على أربع في الصباح، وعلى اثنتين في الظهر، وعلى ثلاث في المساء؟» فأجاب أوديب: «الإنسان؛ يحبو في صغره، ويسير على قدمين في شبابه، ثم يتوكأ على عكاز حين يشيخ.»
فذُهلت السفنكس من دقة الجواب، وألقت بنفسها إلى الهلاك. وعاد أوديب إلى طيبة مكلّلًا بالنصر، فواسته الملكة جوكاستا، التي كانت ترثي زوجها القتيل. ولأنّه خلّص المدينة من بلائها، كوفئ بأن يتزوّج الملكة. وهكذا، دون أن يدري، اكتملت النبوءة الثانية: لقد تزوّج أمّه.
اللعنة التي أحاقت بالعائلة
ومضت السنون، وأنجب أوديب من جوكاستا أربعة أبناء، إلى أن عصفت بطيبة نازلةٌ أخرى: طاعونٌ أهلك الناس. لجأوا إلى العرّافة، فكان الجواب صارمًا: "لن تُرفع الغمّة إلا بالقصاص من قاتل لايوس."
استدعى أوديب النبي الأعمى تيريسياس، فامتنع عن القول، ثم، وقد ألحّ عليه، صرخ بالحقيقة كما سردها سوفوكليس: «أقول إنك أنتَ قاتل الرجل الذي تسعى للعثور على قاتله!»
الضربة القاضية: حين يُبصر القلبُ ما عمي عنه البصر
فما إن أدركت جوكاستا هول المصير، ولم يعد في وسعها احتمال العار أو استيعاب الفاجعة، حتى هرعت إلى مخدعها، وعلّقت نفسها في مشنقة صنعتها بيديها. ويُقال إن أوديب وجدها بعد لحظات، جثّةً هامدة تتدلّى من السقف، فصرخ صرخةً مدوّية، ثم سمل عينيه، جزعًا وندمًا، كأنّما أراد أن يُطفئ نور عينيه اللتين عجزتا عن رؤية الحقيقة، وأن يُبصر بقلبه ما لم يره بعينيه.
ثم نزع التاج، ومضى في التيه، لا يحمل معه غير وزر خطيئته، وعارٍ من كل شيء سوى المعرفة – تلك المعرفة التي لا تُبقي لصاحبها مفرًّا من الندم.
وهكذا، انقلب النصر إلى لعنة، والتحدّي إلى دمار، والذكاء إلى طعنةٍ في خاصرة البصيرة. فأسطورة أوديب، وإن بدت سيرة ملكٍ غلبه القدر، فإنّها في جوهرها صرخةٌ مدوّية في وجه الغرور الإنساني، وتذكيرٌ مُروّع بأنّ الهروب من المصير قد لا يكون إلا دربًا يقود إليه، خطوةً إثر خطوة.
وإنّ ثمّة ما يُعرف اليوم في علم النفس بـ"عُقدة أوديب"، استلهمها فرويد من هذه الأسطورة العتيقة، وجعلها حجر الزاوية في نظريته عن تطوّر النفس البشرية. غير أنّ ذلك حديثٌ يطول مقامه، نؤجّله إلى حين.